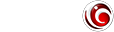"تراب الماس".. عن فنان موهوب وجد ضالته أخيرًا
أحمد شوقي في سينما وتلفزيون
 تراب الماس
تراب الماس
الأحد , 19 أغسطس 2018 - 13:08 | اخر تحديث: الأحد , 19 أغسطس 2018 - 13:08
على مدار اثنتي عشرة سنة، وبالتحديد منذ عُرض فيلمه الأول "عمارة يعقوبيان"، ومروان حامد لا يتوقف عن صناعة الفيلم الأكثر ترقبًا خلال العام. ربما لأنه بدأ من القمة، أو لقدرته الفريدة في سياق السينما المصرية على ألا يتنازل عن تحقيق ما يريده فيما يتعلق بالجودة، أو لأنه يختار دائمًا الانحياز للجماهيرية بمعناها الإيجابي، دون أن ترتبط بالاستمالات الرخيصة والشعبوية، مما كفل لسينماه أن تكون حاضرة ومؤثرة بصورة يستحيل تجاهلها، حتى وإن اختلفت معها.
"عمارة يعقوبيان"، "إبراهيم الأبيض"، "الفيل الأزرق"، "الأصليين"، وأخيرًا "تراب الماس"، خمس تجارب تتشابه في طموحها المرتفع، في تميزها التقني، في مخاطبتها لجمهور السينما العريض (اللهم باستثناء الفيلم الرابع)، وحتى ما تختلف فيه هو أيضًا نقطة تشابه تتمثل في رغبة صانعها أن يدخل عوالمًا جديدة، ويجرب أنواعًا سينمائية مختلفة في كل عمل يُقدم عليه.
ميزات كثيرة يمكن ذكرها في أعمال حامد السابقة، والتي وقفت كلها في منطقة وسطى ذكية بين السينما السائدة والسينما المغايرة، تحاول طرح بعض الأفكار المهمة، لكن في حدود ما يستسيغه الجمهور، تنجح كثيرًا في إدهاشنا بعناصر يفوق مستواها ما سبق مشاهدته في السينما المصرية، وتنجح أيضًا في إحباطنا بأن شيئًا ما ينقص هذه الخلطة لتكون نتيجتها قدر موهبة صناعها وطموحهم. أربعة أفلام ظل فيها مروان حامد ـ على الأقل في نظر كاتب هذه السطور ـ فنانًا يفتش عن عمله الأصيل، عن فيلم يشبهه حقًا، لا يهم أن يكون أفضل الأفلام أو أكثرها ترقبًا، مقابل أن يُعبر ـ شكلًا ومضمونًا ـ عن صانعه. لحسن الحظ، بلغ مروان حامد هدفه أخيرًا في "تراب الماس".
عناصر الفيلم المكتملة
رواية أحمد مراد الأكثر شهرة، والأفضل على مستوى التماسك السردي والدرامي والصلاحية لشاشة السينما، والتي تابع المتحمسون مسارها من يد لأخرى حتى امتلك مروان حامد حقوق تقديمها حسبما يريد، بعيدًا عن سطوة نجم اعتاد التدخل في عمل مخرجين كبار تحت لافتة الحفاظ على صورة ذهنية يحبذها. حامد استعان بنجم لا يقل موهبة، بل يزيد على مستوى الإمساك بشخصية والسير بها من نقطة نفسية لأخرى، بشهادة من الأستاذ داود عبد السيد نفسه الذي قال إن آسر ياسين قد أدهشه في "رسائل البحر"، كما عاد وفعل في "تراب الماس".
كالعادة اختار حامد فريق تمثيل مدجج بالنجوم، وأظهرهم جميعًا في أفضل حال، ولكن الأهم من كل هذه الحسابات هو تقديمه الحكاية كما يريد، من زوايا سردية وفكرية وتقنية مكنته من تحقيق معادلة الفيلم الجيد: الحبكة الجذابة التي تستخدم الأحداث في تحريك المشاعر قبل أن تدفع بها الحكاية، الإمتاع البصري الملائم للعالم الفيلمي، والدفع للتفكير في موضوع رئيسي أو فكرة حاكمة هي العدالة الفردية وشرعيتها في عالم يحكمه فساد يجعل السبل القانونية لإقامة العدالة ضعيفة عاجزة.
في هذا المقال، سنحاول سريعًا المرور بالزوايا الثلاث التي تعامل بها مروان حامد (وأحمد مراد بطبيعة الحال) مع "تراب الماس"، الفيلم الرواية أو الرواية الفيلم، والتي جعلتهما، بعد محاولتين أحدهما تلامس الجودة والأخرى تصل بالكاد لنجاح متوسط، يتمكنان من صنع فيلم سيُذكر طويلًا في مسيرتهما الفنية.
نضج السرد.. الوحدة والمجموع
يبدأ "تراب الماس" بمشهد "فلاش فوروارد"، للبطل طه (آسر ياسين) يصل للمنزل فيجد والده حسين (أحمد كمال) ملقىً على الأرض مصابًا إصابة بليغة قبل أن يتلقى هو الآخر ضربة تفقده الوعي، قبل أن تعود الأحداث للحاضر الفيلمي الذي يسبق الحادث بليلتين أو ثلاث، متقاطعًا مع "فلاش باك" يروي حكاية الأب التي تدور بين مطلع الخمسينيات وأواخر السبعينيات، مع الاستعانة بتعليق صوتي في
مناطق محدودة من الفيلم.
لا يُمكن وصف هذا الشكل السردي بالبساطة، ولا بالتعقد أيضًا، هو فقط شكل معتاد في التعامل مع النصوص الأدبية، يستفيد من نقطة هجوم point of attack مثالية تُقدم حدثًا كبيرًا جذابًا، وتتوازن في تقديم الحاضر الذي تدور فيه الحكاية مع تطعيمه بالماضي (المذكور بإسهاب في الرواية بالتأكيد)، والذي لا غنى عن عرضه مرئيًا لإثراء العمل، بدلًا من الاكتفاء بسرده على لسان شخصية أو أكثر.
اختار مراد هنا الشكل الملائم لكثافة المعلومات وتعدد شخصيات الرواية، دون تكلف زائد يُبعد الفيلم عن الجمهور (كما حدث في "الأصليين")، أو استهتار بما يملكه من مادة درامية. وفي هذا الاختيار الذي يبدو منطقيًا الكثير من النضج يمكن أن نلمسه بمقارنة النص مع سيناريو آخر لفيلم معروض في الموسم الحالي هو "بني آدم"، والذي جمع كل أخطاء تكلف السرد الممكنة، كما سنوضح بالتفصيل في مقالٍ لاحق.
النضج لا يتوقف عند حد اختيارات المؤلف في شكل السرد كمجموع، وإنما يكتمل باكتمال إدراك المخرج الملفت لقيمة اللقطة الواحدة. واللقطة هي أقل وحدة سردية في الفيلم، والتي يتعامل معها بعض المخرجين باستسهال، معتقدين أن الإكثار في القطع والانتقال بين اللقطات يُسرّع من الإيقاع ويزيد جرعة التشويق، بينما حقيقة الأمر أن القطع مسؤولية، واللقطة إن لم تحمل جديدًا (شعورًا أو فكرة أو على أقل تقدير معلومة)، فهي تهبط بالإيقاع لا ترتفع به.
في "تراب الماس" يُقدم مروان حامد والمونتير أحمد حافظ لمخرجي السينما الجماهيرية درسًا في قيمة اللقطة الواحدة، في فضيلة الصبر والتمهل وترقب اللحظة الملائمة للقطع والانتقال بعدما يتشبع المُشاهد باللقطة ويستعد لما يحمله ما يليها من إضافة. أمر كان نتيجته ألا يشعر أحد بزمن الفيلم الذي يتجاوز الساعتين ونصف، بينما لو قام أحد المحللين بحساب عدد لقطاته سنجدها في الأغلب تقل عن أفلام مدتها ساعة ونصف لا نتوقف عن النظر إلى ساعاتنا خلال مشاهدتها.
وبالتفكير في أننا هنا نتحدث عن مخرج قرر في وقت سابق أن يصوّر بعض مشاهد "ابراهيم الأبيض" بعدد ضخم من الكاميرات انعكس بالتأكيد على شكل القطع بينها في المونتاج، فسيمكننا أن نضع يدنا على الرحلة التي قطعها المخرج الموهوب نحو الأنضج والأفضل والأقدر على البقاء.
الفكرة الحاكمة.. قانون ساكسونيا من جديد
في مطلع الثمانينيات قدم الكاتب الكبير وحيد حامد مسلسلًا إذاعيًا فائق النجاح بعنوان "قانون ساكسونيا"، سرعان ما تحوّل واحدًا من أكثر الأفلام التي أثارت الجدل وقتها، "الغول"، الذي طرح فكرة العدالة الفردية بجرأة أتت في وقت بالغ الحساسية، جعل البعض يربط مشهد النهاية الشهير بحادث اغتيال السادات. نفس الفكرة صاغها أحمد مراد على طريقته في الرواية التي صدرت قبل شهور من سقوط نظام حسني مبارك، وقت كان الحديث عن الفساد الشائع والحاكم هو شعار المرحلة المسيطر على الجميع.
مروان حامد هو ابن هذا وذاك، ابن وحيد حامد الذي طالما شغلته تساؤلات علاقة السلطة بالشعب، والفرد بالجماعة، وابن عصره الذي شهد فيه، بحكم الأسرة والموهبة والمهنة، الكثير من الحكايات الواقعية والأسطورية المتعلقة بالشأن نفسه. ولا ننسى أن الأسماء الثلاثة المذكورة: حامد الأب والابن ومراد، يصنفون كنجوم صف أول في لعبة الفن والسياسة، يقدمون رؤيتهم الرافضة للوضع القائم دون قطع أواصر الصلة مع رؤوسه.
ويكفي أن مروان كان يخلد عبارة "إحنا في زمن المسخ" ويعمل محترفًا في إخراج دعايات رئاسية، ومراد يكتب "تراب الماس" بمحتواها الخطير ويعمل في الوقت نفسه مصورًا للرئاسة عينها.
هذا بالقطع ليس تفتيشًا في النوايا فلا أجد في عملهما الاحترافي ما يشين أو يقلل من قدرهما، وما يبقى من المبدع هو أعماله التي تحيا بعده وبعدنا. لكن المقصود هو أن مروان حامد وأحمد مراد عندما يقدمان عملًا عن انتقام المواطن البسيط من رؤوس السلطة الفاسدة، فهما يخوضان موضوعًا يحركهما بالفعل، عاشا تفاصيله عن قرب وكوّنا فيه وجهة نظر نراها في فيلمهما، فيلم ينتمي لهما ويشبههما ويعبر عن فكرة تشغلهما كما تشغل قطاعًا عريضًا من المشاهدين.
في هذا يتفوق الفيلم الجديد على كل ما سبقه من أعمال صناعه، ومقارنته على سبيل المثال بفيلمهما السابق "الأصليين" يمنحنا صورة واضحة عن الفرق بين فنان يقدم فيلمًا تشرب كل تفصيلة فيه فكريًا وإنسانيًا، وفنان يسير وراء هوسه الشكلي فلا يصل في النهاية لغاية ملموسة.
والأهم أن "تراب الماس" يضعنا مع شخصياته أمام خيارين ويورطنا فيهما، يطرح السؤال من منظور واسع ويمنح كل منا حرية ـ ومسؤولية ـ إجابته. صحيح أن الشخصيات تتخذ اختيارها الضروري لاكتمال رحلتهم النفسية والدرامية، إلا أن هذا لا يحدث إلا بعد أن نوقن أن أي خيار، أيًا كان، له ثمن باهظ لا بد وأن يُدفع.
يبقى تحفظ واحد في هذا الصدد هو أن فكرة العدالة الفردية ثمينة وملحة وقيمة في حد ذاتها، كانت تكفي الفيلم تمامًا ليكون عملًا مكتملًا، دون الانخراط في ربط الحكاية بتاريخ مصر وبالوجود اليهودي بعد ثورة يوليو. الأمر الذي يبدو ـ رغم جودة تنفيذه ـ خارج سياق حكاية كان من الأفضل أن تكتفي بما يفيد الحاضر مما وقع في الماضي، والأب كنا سنفهم دلالته بالمقارنة بالبرلماني برجاس دون تأكيد وإعادة تأكيد على هذه الدلالة بمشاهد من الماضي لا تضيف كثيرًا، لا سيما ما يتعلق بعلاقته ـ أي الأب ـ بالفتاة اليهودية.
الواقع الكابوسي.. التقنيات في خدمة الدراما
لا جديد في كون مروان حامد يحيط نفسه بأفضل فريق عمل ممكن، فمجموعة الفنانين الذين يعملون معه بانتظام يكاد كل منهم يكون الأفضل في مجاله، ولا يوجد فيلم لحامد لم يُشاد فيه بالتصوير والديكور والموسيقى والملابس حتى وإن اختلفنا مع الحاصل النهائي لجمع هذه العناصر المتميزة. الجديد في "تراب الماس" هو بلوغ المعادلة السحرية التي يصير فيها مجموع واحد زائد واحد أكثر من اثنين، بتضافر العناصر التقنية لتمنح الفيلم فرادته وتمنحه قيمة تفوق حكايته وتفسيرها.
وإذا كانت الغرائبية هي الاختيار الذي انحاز له مروان حامد في فيلميه الأخيرين، اختيار ربما كان ملائمًا لعالم "الأصليين" لكنه ساهم في خلق مسافة بين المُشاهد وبين "الفيل الأزرق"، الذي ظل حكاية مشوقة جيدة الصنع لكننا لا نصدق حدوثها ولا نتورط فيها بشكل كامل، فإن حامد ينحاز في فيلمه الجديد بشكل واضح ومُعلن من اللحظات الأولى لما يُمكن أن نسميه الواقع الكابوسي.
العالم الفيلمي في "تراب الماس" هو عالمنا الذي نعرفه، الشوارع والميادين والبيوت والحدائق نفسها، ملابس كل الشخصيات تشبه الصيدلي والضابط والبلطجي والمذيع الذين نقابلهم في حياتنا اليومية، وحتى الموسيقى النائحة التي تبكي على حال نعلمه جميعًا لا تبدو آتية من عالم آخر كالألحان التي اعتاد هشام نزيه أن يدهشنا بها في أعمال سابقة. تتضافر جهود نزيه مع محمد عطية في الديكور وناهد نصر الله في الملابس مع كاميرا أحمد المرسي في خلق صورة أسباب جمالها هي نفس أسباب إثارتها للرعب: إنها تشبه عالمنا، وتكشف لنا عن إننا ونحن نسير كل صباح لأعمالنا، قد نكون دون أن ندري الشخصية الرئيسية في حكاية مفزعة لم ندركها بعد.
عندما يتعلق الأمر بفيلموجرافيا مخرج مثل مروان حامد، فهذا التكامل بين العناصر التقنية وخدمتها المثالية للحكاية يعد سببًا رئيسيًا للوقوع في حب الفيلم. ليس فقط لأن المخرج الموهوب تمكن أخيرًا من حشد أدواته وتوجيهها بحنكة لما يريد حكيه، ولكن لأن النتيجة النهائية، مع إضافة المحتوى الفكري والسردي، هي فيلم يمكن اعتباره أكبر أمل تمتلكه السينما المصرية للخروج من أزمة غير مسبوقة تعيشها منذ سنوات.
السينما المصرية التي بَنَت تاريخها الناصع على التنوع والخيارات المتعددة، وما يوفره النجاح التجاري من إمكانية للتجريب في أعمال أخرى تُغطي تكاليفها أو تُغطي أرباح الأعمال الجماهيرية خسائرها الطفيفة، صارت تعيش وضعًا مؤلمًا تحقق فيه أعمالًا شعبوية، أقرب للرداءة منها للجودة، أرباحًا ضخمة بعشرات الملايين، بينما تُمنى كل محاولة للخروج عن السرب أو الانحياز للقيمة بخسائر فادحة تكاد توقف مسيرة صناعها.
لذلك، وجود فيلم كـ"تراب الماس" فرض كفاية. أن تكون هناك سينما متقنة الصنع، قيمة المحتوى، تأخذ المشاهد في رحلة ممتعة ينسى فيها واقعه ويفكر فيه في آن، دون أن تجافي المشاهد العادي أو تتعالى عليه، أو أن تنزل بمستواها لتستميل أحط الغرائز الدرامية، هو أمر لا يمكن إلا أن نسعد به وندعمه ونتمنى له النجاح، لأنه نجاح يساوي نجاة.
اقرأ أيضا:
هذا رأى كندة علوش في فيلم "تراب الماس"
تعرف على إيرادات فيلم "تراب الماس" بعد يومين من عرضه
نرشح لكم
 "الست موناليزا" ينضم للقائمة … حكاية مي عمر والوقوع في حب الرجل الخطأ في مسلسلاتها
"الست موناليزا" ينضم للقائمة … حكاية مي عمر والوقوع في حب الرجل الخطأ في مسلسلاتها
 رضا إدريس: قعدت سنتين من غير شغل وجالي مرض ومكنتش لاقي أدفع إيجار بيتي
رضا إدريس: قعدت سنتين من غير شغل وجالي مرض ومكنتش لاقي أدفع إيجار بيتي
 الدراما التليفزيونية العربية ... بين الريادة المصرية وسر الخلود الباقي
الدراما التليفزيونية العربية ... بين الريادة المصرية وسر الخلود الباقي
 آسر ياسين مهدد بالحبس بسبب دينا الشربيني في الحلقة الرابعة من "اتنين غيرنا"
آسر ياسين مهدد بالحبس بسبب دينا الشربيني في الحلقة الرابعة من "اتنين غيرنا"
 على زغاريد المستشفى أحمد مالك يزف هدى المفتي في لحظات مؤثرة في الحلقة الخامسة من "سوا سوا"
على زغاريد المستشفى أحمد مالك يزف هدى المفتي في لحظات مؤثرة في الحلقة الخامسة من "سوا سوا"
 عمرو سعد يتعرض لخيانة شقيقه في الحلقة الثالثة من "إفراج"
عمرو سعد يتعرض لخيانة شقيقه في الحلقة الثالثة من "إفراج"
 سارة يوسف ومنة شلبي صداقة مصرية فلسطينية بـ"صحاب الأرض"
سارة يوسف ومنة شلبي صداقة مصرية فلسطينية بـ"صحاب الأرض"
 حلمي فودة يكشف أسرار دوره في مسلسل "درش" مع مصطفى شعبان - فيديو
حلمي فودة يكشف أسرار دوره في مسلسل "درش" مع مصطفى شعبان - فيديو
 مواجهة بين ريهام حجاج ومحمد علاء بسبب فيديو لأسماء أبو اليزيد في الحلقة الثالثة من "توابع"
مواجهة بين ريهام حجاج ومحمد علاء بسبب فيديو لأسماء أبو اليزيد في الحلقة الثالثة من "توابع"
 مفاجأة في الحلقة الخامسة من مسلسل المداح 6.. حمادة هلال يُسخر الجن "موت" لمواجهة شرور فتحي عبدالوهاب
مفاجأة في الحلقة الخامسة من مسلسل المداح 6.. حمادة هلال يُسخر الجن "موت" لمواجهة شرور فتحي عبدالوهاب
 سارة يوسف تكشف هويتها الحقيقة لمنة شلبي في الحلقة الثالثة من "صحاب الأرض"
سارة يوسف تكشف هويتها الحقيقة لمنة شلبي في الحلقة الثالثة من "صحاب الأرض"
 فتحي عبدالوهاب يحاول التخلص من حمادة هلال في الحلقة الخامسة من "المداح 6"
فتحي عبدالوهاب يحاول التخلص من حمادة هلال في الحلقة الخامسة من "المداح 6"
 غادة عبد الرازق: اللي بيقول أنه الأعلى أجرا يستفز الجمهور
غادة عبد الرازق: اللي بيقول أنه الأعلى أجرا يستفز الجمهور
 ميرنا جميل عن تعاونها مع محمد إمام: بحبه جدا وبحترمه ومستمتعه بالشغل معاه
ميرنا جميل عن تعاونها مع محمد إمام: بحبه جدا وبحترمه ومستمتعه بالشغل معاه
 غادة عبد الرازق: في بداياتي كنت بدفع فلوس عشان أمثل
غادة عبد الرازق: في بداياتي كنت بدفع فلوس عشان أمثل
 أحمد مالك يخوض صراع الشاب بين (الكرامة والحب والحلم) في الحلقة الرابعة من مسلسل "سوا سوا"
أحمد مالك يخوض صراع الشاب بين (الكرامة والحب والحلم) في الحلقة الرابعة من مسلسل "سوا سوا"
 #شرطة_الموضة: تفاصيل فستان "الانتقام" الذي ظهرت به ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وننسى اللي كان"
#شرطة_الموضة: تفاصيل فستان "الانتقام" الذي ظهرت به ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وننسى اللي كان"
 مسلسل "إفراج" الحلقة الثانية - محاولة قتل عمرو سعد ... وخيانة حاتم صلاح
مسلسل "إفراج" الحلقة الثانية - محاولة قتل عمرو سعد ... وخيانة حاتم صلاح
 وفاء عامر: ريهام حجاج تنتقم بالنجاح ... والتفكير في الانتقام بيعطّل الواحد عن التقدم
وفاء عامر: ريهام حجاج تنتقم بالنجاح ... والتفكير في الانتقام بيعطّل الواحد عن التقدم
 وفاء عامر: لا أوافق على الخُلع بسهولة ... والأبناء هم الضحية الأولى عند خراب البيوت
وفاء عامر: لا أوافق على الخُلع بسهولة ... والأبناء هم الضحية الأولى عند خراب البيوت
احدث الفيديوهات المزيد
 حسين الجسمي يطرح "دنيا وناس وحياة" بمشاركة نجوم الرياضة والفن
منذ يومين
حسين الجسمي يطرح "دنيا وناس وحياة" بمشاركة نجوم الرياضة والفن
منذ يومين
 إصابة هنا الزاهد في "رامز ليفل الوحش": يا نهار أسود ومنيل أنا عندي ديسك في ظهري
منذ يومين
إصابة هنا الزاهد في "رامز ليفل الوحش": يا نهار أسود ومنيل أنا عندي ديسك في ظهري
منذ يومين
 لأول مرة.. كريم الشناوي مخرج إعلانات في رمضان
منذ يومين
لأول مرة.. كريم الشناوي مخرج إعلانات في رمضان
منذ يومين
 أسماء جلال تصرخ في "رامز ليفل الوحش": أنا مش مرتبطة بفنان مطلق .. ومعملتش "أنفولو" لهنا الزاهد
منذ يومين
أسماء جلال تصرخ في "رامز ليفل الوحش": أنا مش مرتبطة بفنان مطلق .. ومعملتش "أنفولو" لهنا الزاهد
منذ يومين