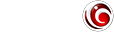خاص أحسن 20 فيلمًا عربيًا في 2019 (قائمة شخصية)
أحمد شوقي في سينما وتلفزيون
 من أحسن 20 فيلما في 2019
من أحسن 20 فيلما في 2019
الجمعة , 27 ديسمبر 2019 - 20:12 | اخر تحديث: الجمعة , 27 ديسمبر 2019 - 22:12
95 فيلمًا طويلًا من إنتاج العام، بين روائي وتسجيلي، هي حصيلة مشاهدات 2019. 95 فيلمًا من 13 دولة تمثل تقريبًا كل جديد السينما العربية الذي يمكن أخذه على محمل الجد، باستثناء بعض الأفلام التجارية الخفيفة في مصر ولبنان والمغرب.
كان من حسن حظي مجددًا أن امتلكت تلك الفرصة الذهبية بالجمع بين العمل بالنقد والبرمجة، مما سمح بإلقاء هذه النظرة البانورامية على الإنتاج العربي، لتأتي تلك القائمة السنوية للعام الثاني على التوالي. والتي لا بد وأن أؤكد قبل أن يبدأ القارئ الإطلاع عليها أن معايير اختيار الأفلام وترتيبها شخصية بحتة، تتعلق بذائقة الكاتب وتفضيلاته التي يمتلك الجميع بطبيعة الحال حق الاتفاق والاختلاف معها، فهذا بالتحديد هو المطلوب لخلق زخم نقدي يتعامل مع الحراك الحادث في السينما العربية بجدية كتيار إبداعي وإنتاجي، وليس مجرد محاولات منفردة متناثرة، لا سيما ونحن في نهاية عام حققت فيه الأفلام العربية إنجازات مشهودة في أغلب مهرجانات العالم الكبرى. فلنبدأ العشرين فيلمًا الأحسن في 2019.
20. طلامس (تونس)

نادرًا ما تشغل الأفكار المجردة كالعلاقة بين البشر والطبيعة أذهان صناع الأفلام العرب، لكن التونسي علاء الدين سليم يواصل في فيلمه الثاني مقارباته لعلاقتنا بعالمنا. الطموح هنا شاهق لا يقل عن إعادة كتابة التاريخ الإنساني من منظور مغاير، ثائر على كل القواعد الموروثة والتراتبيات التقليدية. آدم وحواء نسخة 2019: جندي هارب من الجيش وزوجة فرّت من زوجها. بهما يعيد سليم تأسيس كل شيء، يخترع لغة جديدة للتواصل، ويمزج السمات الفسيولوجية ليكون لدينا في عالم الطلامس رجلًا يرضع ابنًا لم ينجبه! قد يعيب الفيلم بعض المباشرة التي لم نرها في فيلم المخرج الأول، لكنه يبقى أحد أجرأ تجارب العام في السينما العربية.
19. امباركة (المغرب)

أكثر من باب يطرقه المغربي محمد زين الدين في فيلمه الذي لم ينل ما يستحقه من تقدير: يستلهم الدراما الكلاسيكية في مثلث (الأم/ الابن/ العشيق)، يخوض في عوالم الطب الشعبي الأقرب للسحر من مدخل أقرب للنسوية، ويجعل من المدينة ـ خريبكة ـ شخصية فاعلة في الأحداث. مدينة الفوسفات الجافة، القاسية حتى على محبيها، لا يمكن فصلها هنا عن كل ما يدور فيها من أحداث فيلم يمتلك الكثير من أسباب الإعجاب، هو واحد من فيلمين عربيين كانا يستحقان عرضًا أول في مهرجان أكبر خلال العام.
18. بابيتشا (الجزائر)

من النادر أن تجد فيلمًا أفضل وأسوأ ما فيه شيء واحد مثل فيلم مونيا مدوّر.. بالنسبة للكثيرين "بابيتشا" لطيف أكثر مما ينبغي too cute، تكاد حكاية المراهقات الحالمات بتنظيم عرضًا للأزياء تخون ـ بسلامة نيّة ـ حجم المأساة المجتمعية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء. إلا أنه تلك اللطافة تمنح الفيلم في الوقت ذاته جاذبيته الخاصة، حتى لو كانت صورة الواقع غير دقيقة، فنحن في النهاية نراه من أعين فتيات مراهقات. بينما تُمثل نهاية الفيلم المفجعة تحية باكية لكل من حلم يومًا أن التفاؤل والبهجة وتحدي الأوضاع الراهنة أمور كافية للتغلب على الواقع المخيف، ليصير "بابيتشا" تحية للـ"مراهقة" وما تعنيه على كافة المستويات.
17. نوره تحلم (تونس)

لو كان القياس يكتفي بالفصول الأولى لقفز فيلم هند بوجمعة لأحد المراكز الأولى في هذه القائمة، بما يمتلكه من فصل أول مدهش في قدرته على وضعنا داخل مأزق لا حل له، بين ثلاث شخصيات يمكننا تفهم موقف كل منهم كليًا، وبأداء تمثيلي آخاذ من اللحظة الأولى من هند صبري، الرابح الأكبر من التجربة. المرأة أيضًا من حقها أن تعشق وتلبي احتياجات جسدها، لكن هل يحترم المجتمع ذلك الحق؟ تلك هي نقطة الانطلاق الممتازة التي يمتلكها الفيلم، قبل أن يتعثر بعض الشيء في فصوله اللاحقة فلا يحافظ على نفس المستوى من القدرة على إحداث الصدمة بأدوات الفن السابع. لكن يبقى "نوره تحلم" أكثر أفلام 2019 العربية نسوية، إن كانت النسوية هي السعي لإقناع العالم أنه من العبث أن يكون للفعل ذاته آثار مختلفة وفقًا لجنس مرتكبه.
16. بيروت المحطة الأخيرة (لبنان)

هناك حقائق صادمة كثيرًا ما نغفل دلالاتها. القاهرة مثلًا أقرب للقدس منها للأقصر، والقطار كان يتحرك بينهما يوميًا. لبنان واحد من البلدان المعدودة في العالم التي لا تمتلك أي شبكة مواصلات عامة، لكنه ـ وياللعجب ـ كان من أوائل الأقطار التي امتلك تلك الشبكة قديمًا. ما الذي جرى فجعل المحطات القديمة المتهالكة تغدو أطلالًا تشهد على ماضٍ دامٍ؟ سؤال كبير يطرحه وثائقي المخرج إيلي كمال، ويحاول الإجابة عنه بأكثر الأدوات سينمائية: الصورة والإيقاع. إيقاع تأملي يحتاج مجهودًا للولوج إلى ثناياه، وصورة مدهشة في قدرتها على إبراز جماليات الرُكام، وربط ذكي بين العام والخاص بحيث يُكمل كل منهما الآخر دون أن يتقاطعا.
15. أبو ليلى (الجزائر)

إذا كان "بابيتشا" مونيا مدوّر ينتهج لطف المراهقة في معالجة التاريخ الدامي، فإن "أبو ليلى" أمين سيدي بومدين يُقدم على الفعل العكسي، الأكثر جرأة، يدفع الدموية والجنون إلى حدها الأقصى. لا مجال هنا للمحاضرات، التاريخ حاضر في مكان ما، في الخلفية أو السياق ومكالمات الهاتف وأخبار التلفزيون، لكنه في النهاية لا يهم. ما يهم هو النفس البشرية بتعقدها وتشوهاتها، بألاعيب وتوازنات القوى التي نظن أنها تحكم المجتمعات ثم ندرك كونها تحكم كل شيء، حتى العلاقة بين صديقين يخوضان رحلتهما في الصحراء الجزائرية بحثًا عن أبو ليلى.
14. بعلم الوصول (مصر)

بالنسبة للقناعة السائدة عند قطاع عريض من مجتمعاتنا المرض النفسي رفاهية يصعب أن "يتمتع" بها الفقراء. هذه قناعة راسخة على سذاجتها يكسرها المخرج هشام صقر (الآتي من عالم المونتاج بتمكن يسهل رصده) ليضع الحقيقة المؤلمة نصب أعيننا، ويرينا بحكايته المؤلمة كيف يمكن للمرض النفسي ـ وألاعيب القدر أحيانًا ـ أن تحيل حياة أسرة بسيطة مُحبة جحيمًا، وكيف يمكن لهذا الجحيم أن يكون بشكل ما وسيلة لاستكشاف الماضي والتصالح معه. يبرع صقر في استخدام الواقع مساحة لأحداثه: شقق الطبقة الوسطى السكنية وردهاتها، الشوارع والمدارس وتفاصيل الحياة اليومية، كلها أمور تزيد من هول المأساة، فقط لأن الفيلم يخبرنا في كل لحظة أن ما تراه على الشاشة من الوارد أن يحدث لك.
13. سيد لمجهول (المغرب)

لدى فيلم المخرج علاء الدين الجمّ الكثير مما يمكن نسبه للمسرح: وحدة المكان وتقشف عناصره، الشخصيات ذات الطابع الكاريكاتوري، والموضوع المستلهم بوضوح من تراث الدراما. لكن المخرج الشاب يمزج الأدوات المسرحية فيصنع منها فيلمًا سينمائيًا غير معتاد. "سيد لمجهول" عمل ساخر، مينيمالي minimalistic، لا يكتفي بسخرية مطروقة حول "صناعة الوليّ"، وكيف تميل الثقافات البدائية عادة لخلق أسطورة والالتفاف حولها، بل يمتد لكيفية تحويل هذه الأسطورة إلى اقتصاد وأسلوب حياة. تصرفات سكان القرية المتكررة، العبثية في دأبها، تحمل داخلها رؤية لتاريخ الحضارة في عالمنا العربي، ناهيك عن كونه أحد أخف أفلام العام العربية ظلًا.
12. احكيلي (مصر)

ما أجمل الأفلام التي تُقربنا من بعضنا البعض، والتي تجعلنا ندرك أننا - على اختلافنا - متشابهين. المخرجة ماريان خوري تعود بعد سنوات من الغياب بفيلم يبدو ظاهريًا شديد الذاتية، كيف لا وبطلاته هم نساء عائلتها ومشاهدته تم تصويرها في تجمعات العائلة ونقاشات أفرادها؟ لكن هذا الوثائقي الذي يدور في أروقة عائلة اعتدنا اعتبارها "طفرة" يتسلل برويّة للعقول والقلوب، فندرك بعقولنا أن آل يوسف شاهين ما هم في النهاية إلا نسخة من أي عائلة مصرية أخرى. صحيح إنها نسخة تمزج في حديثها بين ثلاث لغات على الأقل، لكن اللغات تروي نفس الحكاية المعتادة، حكاية المرأة الراغبة في إيجاد مساحتها من العالم دون أن تفقد تصالحها مع ذاتها وجذورها.
11. آدم (المغرب)

يكاد فيلم المخرجة مريم توزاني يخلو من أي وجود مؤثر للرجال، لكن أثرهم واضح في كل ثناياه، وحين يصير "الغياب" بهذا "الحضور" نوقن أن هناك مشكلة أزلية يحاول "آدم" إطلاق صيحة في وجهها. يمكن عقد مقارنة من بعيد بين فيلم توزاني و"طلامس" علاء الدين سليم من حيث محاولة كل منهما تقديم نسخته الخاصة من العالم الجديد (لاحظ دلالة منح اسم البشرية الصفري للطفل والفيلم)، لكن "آدم" وإن بدى أكثر كلاسيكية في خياراته السردية والجمالية، فهو أيضًا أكثر حميمية، ذو طابع حسي، يتسحّب داخل عالم النساء بخفر مُحبب، ولا يغادره دون أن يضمن وقوعنا في حب ثلاثة منهن على الأقل!
10. ع البار (تونس)

تظل كرة القدم سؤالًا أزليًا موجهًا للسينما: كيف يمكن أن يظل حضور نشاط يومي يمتلك كل هذا التأثير المذهل على البشر مقتصرًا على عدة أفلام متناثرة، نادرًا ما يوجد بينها فيلمًا له قيمة حقيقية؟ السينما العربية على وجه الخصوص لم تنتج في تاريخها ما يتجاوز أصابع اليدين من أفلام عن الشيء الوحيد الذي يمكن الجزم بأن الغالبية تتابعه وتتفاعل معه بكل جوارحها. من هنا تأتي قيمة فيلم سامي التليلي الذي ينتبه لحقيقية بديهية هي أن للكرة أثر أنثروبولوجي يمكن رصده سينمائيًا، وأن حكاية غدت أسطورة كرحلة المنتخب التونسي نحو كأس العالم 1978، يمكن روايتها بشكل مغاير يكشف صلتها الوثيقة بالتاريخ المعاصر للبلد.
9. الشغلة (مصر)

العنوان الثاني في قائمة الأفلام التي كانت تستحق عرضًا أول أفضل مما نالته، وربما كان "الشغلة" يستحق أيضًا عملًا أكبر في مرحلة ما بعد الإنتاج التي تم إنهائها بعدما رحل المخرج رامز يوسف عن مصر تاركًا الفيلم لمنتجيه المقاتلين. قيمة الفيلم لا تقتصر على خوضه في عالم غير مطروق بهذا التمكن من نيل ثقة الشخصيات ودفعها للحديث بأريحية عن مهنة يعتبرها القطاع الأعرض من المجتمع في حكم القوادة (الإشراف على عمل الراقصات الشعبيات)، ولكن لأن الفيلم يفعل ذلك مظهرًا الحد الأدنى من الأحكام الأخلاقية، تاركًا المفارقة في حكايات أصحاب "الشغلة" تبني شعورًا متباينًا لدى المشاهدين عن عالم اعتادوا الخجل منه أو إنكار وجوده.
8. سيدة البحر (السعودية)

نظريًا، لدى فيلم شهد أمين كل ما يجعله جديرًا باهتمام المجتمع السينمائي الدولي: عمل أول لمخرجة سعودية من جيل يترقب الجميع ماذا سيُقدم، قصة مستمدة من تراث الخليج ومعالجة تجعل منها حكاية نسوية بامتياز، وخيارات بصرية وسردية جريئة تخرج من حيز الحكي المباشر إلى مناشدة الإنجاز البصري. كل ما سبق كان من الممكن أن يُسفر عن عمل جاف، عقلاني، مصنوع وفقًا لمعادلات، لكن يظل أفضل ما في "سيدة البحر" هو قدرة صانعته على تطويع العناصر السابقة وتغليفها ببصمتها الإخراجية، بصمة رقيقة وحالمة وشاعرية، بحيث تجعلك تتناسى المعادلات وإن أدركتها، وتنغمس في عمل لديه سحره الخاص.
7. جدار الصوت (لبنان)

نضج حياتي وسينمائي كبير يُظهره أحمد غُصين في فيلمه الطويل الأول، سواء على مستوى فهم تجربة الحرب وأهوالها، وكيف أن أغلب ذكريات الحرب لدى من عاشوها هي ذكريات صوتية بالأساس: متابعة صوت القذيفة وترقب موقع هبوطها، أو على مستوى تحويل هذا الفهم خياراتٍ إخراجية يمكن لمسها، مقدمًا واحدًا من أكثر أشرطة الصوت تأثيرًا في السينما العربية خلال العام. بخلاف ما سبق، يحمل "جدار الصوت" رؤية موازية لعلاقة الأجيال، فإذا كان الجدل بين الشباب والعجائز وذكريات الزمن الجميل شيئًا حاضرًا في كل المجتمعات، ففي لبنان للأمر أبعادًا أخرى في ظل كون كل جيل سابق قد شارك ـ إن لم يكن تسبب ـ في حربٍ أهلية ما!
6. شارع حيفا (العراق)

تكاد السينما العربية تخلو من نوعية عوالم ما بعد المحرقة Post-apocalyptic المشهورة في أفلام الخيال العلمي، والتي تعرض العالم بعد تعرّضه لكارثة أودت بالحضارة وردّت البشر لصورتهم الحيوانية. ما يفعله المخرج مهند حيّال في فيلمه الأول هو تذكيرنا بأن ما يقدمه العالم في أفلام خيالية كان ـ وربما لا يزال ـ واقعًا في بعض شوارع العرب، بل في أحد أعرق شوارع العرب. شارع حيفا التاريخي وقد تحول ساحة دموية لا مكان فيها حتى لقوانين الحروب. عندما يسيطر الجنون والذعر تذوب حتى الفوارق بين الجريمة والبطولة. فيلم قاس عن لحظة بلغت فيها مدينة عظيمة أقصى صور الخراب والبدائية.
5. 143 طريق الصحراء (الجزائر)

يُثبت المخرج حسن فرحاني في هذا الوثائقي البديع أن السينما الجميلة لا تحتاج ميزانيات ضخمة أو حكايات متحذلقة، فقط يكفي قدرة صانع أفلام على إيجاد الشخصية المناسبة في المكان المناسب، ليدع الواقع يلعب لعبته ويُقدم حكاية تحمل كل لحظة فيها إجابة على تساؤل أزلي: كيف يمكن للواقع ورتابته أن يحمل سحرًا يفوق الخيال في تأثيره؟ تلك المرأة البسيطة التي تدير مقهى خال من كل أسباب الإبهار، والمنقطعة عامدة عن الانخراط الفعلي فيما يعج به العالم بعيدًا عن مقهاها، تغدو في نهاية الفيلم رمزًا لكل ما هو إنساني ودافئ وقريب من القلب.
4. بيك نعيش (تونس)

يسير المخرج مهدي برصاوي على حبل رفيع بمهارة لاعب سيرك، أي تعثر كفيل بأن تسقط حكايته أما في فخ الميلودراما على الطريقة المصرية الكلاسيكية أو في شراك الأفلام المستشرقة التي تنظر للشخصية الدرامية العربية كرمز لجماعة أو طبقة عوضًا عن كونهم بشر من لحم ودم. لحسن الحظ ـ وموهبة المخرج ـ يبلغ "بيك نعيش" بر الأمان، مقدمًا صورة نموذجية لإمكانية تقديم حكاية زخمة بالانقلابات الدرامية دون الاستسلام لتخلي المخرج عن سلطته في التحكم بكل لحظة. أداء تمثيلي رفيع من البطل سامي بوعجيلة الذي يطرح صمته وحيرته السؤالين الكبيرين: ما الذي يعنيه أن تكون أبًا؟ وإلى أي مدى يمكن للإنسان أن يمضي سعيًا لإنقاذ من يُحب؟
3. إن شئت كما في السماء (فلسطين)

عودة كبيرة تليق بأحد أهم صناع السينما العربية عبر تاريخها. إيليا سليمان يواصل لعبته المفضلة، الرصد الساخر للعالم على طريقته: المشاهد الأقرب للوحات المنفصلة، الاهتمام المدهش بالميزانسين الذي يتحول لما يشبه الكوريوغرافي، استلهام النكتة من رحم عبث الحياة اليومية. في عالم إيليا أن تكون فلسطينيًا هي مشكلة، وفي "إن شئت كما في السماء" أن تكون فلسطينيًا عالم 2019 هي مشكلة أكبر. انطلاقًا من أذكى وأطرف مشهد افتتاحي في سينما العام العربية، ورحيلًا من فلسطين لفرنسا للولايات المتحدة، يخبرنا إيليا دون كلمات ـ أو بأربعة كلمات فقط إن أردنا الدقة ـ أن معايشة الاحتلال حاليًا لم تعد تحتاج جدارًا عازلًا وحواجز تفتيش.
2. الحديث عن الأشجار (السودان)

يحقق فيلم صهيب قسم الباري كل هدف ممكن وضعه للفيلم التسجيلي، إذا كان الغرض هو تقديم حكاية حقيقية صادقة ومشوقة فلا أرق من حكاية آباء السينما السودانية الأربعة، وإن كان المراد أن تحمل القصة ما هو أعمق من مستواها الأول فالعمل يطرح بهدوء وذكاء ودون مباشرة رؤية لما تعرض له السودان طيلة عقود، ولو كان الهدف الأسمى هو التقريب بين البشر فالمشاهد يخرج من "الحديث عن الأشجار" واقعًا في غرام الشعب السوداني بأكمله، الذي يأتي ما حققوه خلال العام وكأنه مكافأة نهاية الخدمة للأربعة العظماء أبطال الفيلم، مكافأة تنبأ به نجيب محفوظ عندما كتب وكأنه يخاطبهم: "لا تجزع فقد ينفتح الباب ذات يوم تحية لمن يخوضون الحياة ببراءة الأطفال وطموح الملائكة".
ستموت في العشرين (السودان)

العمل الأكثر اكتمالًا في السينما العربية لعام 2019. حكاية ذات طموح شاهق تقارع أفكارًا بحجم الحياة والموت والدنس والطهر والإيمان ورفضه، وبعد روائي واضح يجعل كل شخصية وكل فعل أو حدث ثريًا بتفسيرات عدة، إحكام بصري يبلغ حد التشكيلية في كل لقطة تقريبًا، وتشبع بتراث سينمائي وأدبي لا يخجل الفيلم من تقديم أكثر من تحية له. "ستموت في العشرين" عمل ولد كبيرًا، كان أشبه بعصا موسى التي ألقى بها أمجد أبو العلاء لتنتزع غالبية الإعجاب في عام مليئ بالأفلام الجيدة. فيلم مُشبع على الأصعدة الثلاثة: سرديًا وفكريًا وبصريًا، يأتي من منطقتنا التي اعتدنا فيها أن نقنع بإشباع واحد، وأن نطلق على من يُحقق إشباعين عملًا عظيمًا!
نرشح لكم
 عمرو مصطفى يعلق على أزمة رقم 1 و19: ماسمعش صوت ... هتوحشوني اوي
عمرو مصطفى يعلق على أزمة رقم 1 و19: ماسمعش صوت ... هتوحشوني اوي
 "ماجد ابن الناس راجع.. بس مش أي راجعة" ... نور النبوي ينشر البوستر الشخصي لـ(الحريفة 2 - الريمونتادا)
"ماجد ابن الناس راجع.. بس مش أي راجعة" ... نور النبوي ينشر البوستر الشخصي لـ(الحريفة 2 - الريمونتادا)
 لبلبة تكشف وصية والدتها الأخيرة: أحتفظ بفساتينها وطقم أسنانها والقصافة والمشط
لبلبة تكشف وصية والدتها الأخيرة: أحتفظ بفساتينها وطقم أسنانها والقصافة والمشط
 دينا الشربيني تكشف عن بوستر مسرحية "حاوريني يا كيكي" ... تعرض في موسم الرياض
دينا الشربيني تكشف عن بوستر مسرحية "حاوريني يا كيكي" ... تعرض في موسم الرياض
 رمضان 2025 - منة فضالي تبدأ تصوير مشاهدها في "سيد الناس"
رمضان 2025 - منة فضالي تبدأ تصوير مشاهدها في "سيد الناس"
 رمضان 2025 - أحمد زاهر ينضم لمسلسل "سيد الناس" ويبدأ تصوير مشاهده
رمضان 2025 - أحمد زاهر ينضم لمسلسل "سيد الناس" ويبدأ تصوير مشاهده
 عمرو يوسف ومحمد ممدوح يتعاقدان على الجزء الثاني من فيلم "شقو" (صور)
عمرو يوسف ومحمد ممدوح يتعاقدان على الجزء الثاني من فيلم "شقو" (صور)
 لبلبة: دفنت والدي ورجعت عملت مكياج وغنيت للناس على المسرح
لبلبة: دفنت والدي ورجعت عملت مكياج وغنيت للناس على المسرح
 أكثر من 142 عارضا من 32 دولة - سوق البحر الأحمر يكشف تفاصيل برامجه ولجان التحكيم لدورته الرابعة
أكثر من 142 عارضا من 32 دولة - سوق البحر الأحمر يكشف تفاصيل برامجه ولجان التحكيم لدورته الرابعة
 إنجي كيوان أمام ياسمين عبد العزيز لأول مرة في "وتقابل حبيب" لرمضان 2025
إنجي كيوان أمام ياسمين عبد العزيز لأول مرة في "وتقابل حبيب" لرمضان 2025
 الصورة الأولى لـ بسمة داود من فيلم "إسعاف" أول أعمالها في السعودية
الصورة الأولى لـ بسمة داود من فيلم "إسعاف" أول أعمالها في السعودية
 أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم في برومو "فقرة الساحر" (فيديو)
أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم في برومو "فقرة الساحر" (فيديو)
 أخفى الأمر عن أهله ... حكاية انضمام فاروق فلوكس للفدائيين في بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي
أخفى الأمر عن أهله ... حكاية انضمام فاروق فلوكس للفدائيين في بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي
 رمضان 2025 - ياسمينا العبد تنضم لأبطال مسلسل "لام شمسية"
رمضان 2025 - ياسمينا العبد تنضم لأبطال مسلسل "لام شمسية"
 الصور الأولى لنيكول سابا من كواليس "وتقابل حبيب"
الصور الأولى لنيكول سابا من كواليس "وتقابل حبيب"
 رمضان 2025- الصور الأولى لـ أحمد السعدني من مسلسل "لام شمسية"
رمضان 2025- الصور الأولى لـ أحمد السعدني من مسلسل "لام شمسية"
 "شكرا لأنك تحلم معنا" يحصد جائزة جديدة في مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة
"شكرا لأنك تحلم معنا" يحصد جائزة جديدة في مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة
 رمضان 2025 – سلاف فواخرجي تجسد شخصية أول ممثلة سورية في "ليالي روكسي"
رمضان 2025 – سلاف فواخرجي تجسد شخصية أول ممثلة سورية في "ليالي روكسي"
 المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس محمد أبو بكر شهرين وغرامة 50 ألف جنيه ... وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه
المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس محمد أبو بكر شهرين وغرامة 50 ألف جنيه ... وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه
 مهرجان الفيوم السينمائي ينظم يوما فلسطينيا يتضمن أنشطة وعروضا مختلفة
مهرجان الفيوم السينمائي ينظم يوما فلسطينيا يتضمن أنشطة وعروضا مختلفة
أهم الأخبار
 #شرطة_الموضة: ياسمين صبري بفساتين قصيرة من Prada وتسريحة شعر ملفتة
#شرطة_الموضة: ياسمين صبري بفساتين قصيرة من Prada وتسريحة شعر ملفتة
 ويجز يرد على رامي صبري: سامحتني قبل ما اعتذر؟ أنت لسه صغير أوي بالتوفيق يا مجتهد يا شاطر
ويجز يرد على رامي صبري: سامحتني قبل ما اعتذر؟ أنت لسه صغير أوي بالتوفيق يا مجتهد يا شاطر
 هالة صدقي تبرئ عمر زهران من سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف
هالة صدقي تبرئ عمر زهران من سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف
 محمد لطفي وعماد زيادة وأحمد عصام وبوسي شلبي .. نجوم الفن يساندون حمادة هلال في وفاة حماه
محمد لطفي وعماد زيادة وأحمد عصام وبوسي شلبي .. نجوم الفن يساندون حمادة هلال في وفاة حماه








.jpg)