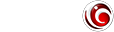خاص فيلم "توب العيرة".. رحلة البحث عن وطن بديل
أمل مجدي في سينما وتلفزيون
 توب العيرة
توب العيرة
الأحد , 17 مارس 2019 - 15:03 | اخر تحديث: الاثنين , 18 مارس 2019 - 13:03
في فيلمها التسجيلي الطويل الأول "توب العيرة"، المشارك ضمن مسابقة أفلام الحريات في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تتناول المخرجة السورية لين الفيصل أزمة الحرب في بلدها من منظور إنساني شديد الخصوصية، بعيدا عن الأرقام والإحصاءات الجامدة التي تركز عليها نشرات الأخبار، أو صور الدمار والخراب التي بالرغم من قسوتها فقدت الكثير من تأثيرها على النفوس بعدما باتت مكررة على شاشات التليفزيون والسينما.
تختار الفيصل تحريك الكاميرا ناحية عائلتها المشتتة في أماكن متفرقة من العالم، وتركز على ثلاث شخصيات من أجيال مختلفة يفتحون جراح الروح أمام الجميع، ويبوحون بما فعلته الحرب في حياتهم، بعيدا عن الوضع السياسي المعقد. فهم أناس اضطرتهم الظروف القهرية إلى مغادرة الوطن، والسفر إلى بلاد أخرى في محاولة لتأسيس حياة جديدة، لكن أرواحهم تعاني من فراق الأحبة، وتحن إلى ماضي جميل، كانت فيه الحياة رائقة خالية من لحظات الوداع الكئيبة.
يتبنى الفيلم فكرة أن الوطن هو الملاذ الحقيقي الذي يشعر فيه الإنسان بالراحة، مهما كانت الظروف سيئة. فقد يقيم في أجمل بقاع الأرض، لكن يبقى تائها يحلم بالعودة لموطنه الأصلي. من هنا يأتي الاسم المستمد من المثل الشامي "توب العيرة ما بيدفي و إن دفا ما بيدوم". فعائلة لين الفيصل تفرقت بين الإمارات ولبنان وعدد من الدول الأوروبية، وبالرغم من أنها بلاد الأحلام التي تمر عليها الكاميرا سريعا مستعرضة بهائها ونظامها، فإنها تظل بالنسبة للسوريين مجرد أماكن معدومة الروح، يعيشون فيها مغتربين يشعرون بالمرارة والقهر والغضب.

يمكن اعتبار أن الشخصيات الثلاثة الرئيسية تقدم تمثيلا حيا لحال السوريين في الماضي والحاضر والمستقبل. فالجدة (سوسو) ذات الثمانين عامًا، هي جذر شجرة العائلة التي لا تطيق الاقتلاع من أرضها، وتلح باستمرار على العودة إلى الوطن. فكل ما تتمناه في هذه الحياة أن تجلس في شرفة منزلها الدمشقي لاحتساء قهوتها في هدوء، مثلما اعتادت في الماضي. أما ابنتها (دعاء) فهي سيدة شجاعة، تحاول مواجهة الحاضر القاسي الذي فرقها عن أبنائها، فتقبل خيار إعادة التوطين في بلد أوروبي على أمل لم شتات الأسرة الممزقة، تاركة ورائها ابنها الصغير عالقا في بيروت. فقد بات مكتوبا عليها أن تتحمل ألم الفراق في ظل الوضع الحالي. في حين أن الابن (سعد) الذي لم يتجاوز الثمانية عشر عامًا، يقيم بطريقة غير شرعية عاجزا عن تحقيق أحلامه، ويواجه مستقبل بلا معالم واضحة.
تعتمد الفيصل على أسلوب كاميرا الواقع التي تنقل الأحداث حية دون تزييف، فتبدو الصورة أقرب إلى ألبوم صور عائلي، يوثق كل ما يحدث فى حيواتهم، كل ما يمر بهم، خوفا من ضياع ذكرياتهم، وخشية من أن يمحوها الزمن بقسوته المعتادة. فهناك اهتمام شديد بتفاصيل الأماكن التي يعيشون بها، وشكل البنايات والأسطح، وأسماء الشوارع، إلى جانب تتبع الشخصيات أثناء قيامهم بالممارسات اليومية المعتادة، وتحديدا إعداد الطعام، الذي يعتبر وسيلة من وسائل العودة إلى الوطن وشم رائحته.
وقد غلبت التلقائية على أسلوب الحكي وتميزت مشاهد التجمعات العائلية بالعفوية الشديدة، نظرا لانعدام الحواجز بين من يتواجد أمام الكاميرا ومن يقف خلفها. كل هذه السياقات الإنسانية ساعدت على تعزيز الشعور بالتماهي مع الشخصيات ومأساتها. لأننا إذا نظرنا إلى هذه العائلة بصرف النظر عن جنسيتها، سنرى أنه لا يوجد فرق بينها وبين أي عائلة في مجتمع آخر. فالجميع معرضون لنفس المصير المهلك إذا دق ناقوس الحرب.

الفيلم أشبه بسيرة ذاتية لمخرجته الحاضرة باستمرار من خلال التعليق الصوتي والمواد المصورة التي تمثل زمنا اعتباريا يرتبط بذكريات الطفولة. وقد كانت هناك مجموعة من الأسئلة تشغل بالها طوال الوقت، حول معني الوطن وفكرة الانتماء لمكان محدد، وهل نرتبط بالجدران والمباني أم بالأشخاص الذين يعيشون داخلها؟ ظلت تبحث عن إجابات بين شوارع البلدان المختلفة، ثم أصبحت أكثر تفاعلا مع الحدث عندما عادت إلى دمشق لتعرف بنفسها. هنا يصبح الفيلم أكثر نضجا في تناوله للأزمة السورية، لأنه يخرج من عباءة الحنين إلى الماضي والذكريات، ليواجه الواقع الحقيقي. فحالة الانقسام التي خلفتها الحرب أحدثت فجوة بين الناس حتى وإن تم التظاهر بعكس ذلك، وبالتالي تبدل حال الوطن ربما إلى الأبد، ولم يعد المكان الذي يضم الجميع بصرف النظر عن اتجاهاتهم ومواقفهم السياسية.
تحاول المخرجة طوال الأحداث أن تكون متمسكة بالجانب الإنساني من حكاية عائلتها، لكن هذا لم يمنع من وجود بعض التلميحات السياسية المباشرة. ففي بداية الفيلم، نستمع من خلال مقطع مصور أرشيفي لنشيد الطلاب في المدرسة عن الوحدة العربية، في إشارة واضحة إلى التخاذل العربي تجاه الشأن السوري الآن. وفيما بعد يتم التطرق إلى تعامل العرب مع اللاجئين بطريقة تتسم بالبيروقراطية، وصولا إلى الجملة المتروكة في المنزل اللبناني التي توضح مدى حاجة اللاجئ إلى الدفاع عن نفسه باستمرار. صحيح أن هذا الجانب بعيد عن سياق الفيلم العام، لكن تم بلورته لإظهار الضغوط التي يتعرض لها هؤلاء البشر.
أهمية "توب العيرة" كامنة في تركيزه على الضرر النفسي الواقع على اللاجئين، لأن النظرات القاصرة ترى أنهم أفضل حالا من الذين يعيشون في مدن تحت الحصار محرومة من الاحتياجات الأساسية في الحياة. لكن لا أحد ينجو من الحرب. فهؤلاء المعذبون في أوطان لا ينتمون إليها، محرومون من حرية الاختيار، ومجبرون على الفراق، غير قادرين على تجاوز الحدود الجغرافية التي تفصل بين البلدان. وحتى إن تخطوها متحلين بروح الشجاعة، سيجدون أنفسهم محاطين بالوحدة من كل اتجاه، يشعرون بالغربة في موطنهم الأصلي، إلى حين إشعار آخر...
اقرأ أيضًا:
إدريسا أودراجو.. مناضل في ميدان السينما
الأجندة - فعاليات اليوم الأول لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
نرشح لكم
 أحمد رفعت: أنا أقل الفنانين أجرا وجاملت المنتجين في أعمال كثير
أحمد رفعت: أنا أقل الفنانين أجرا وجاملت المنتجين في أعمال كثير
 أحمد رفعت: بقالي 3 سنين مش بشتغل وفي فنانين بلاقيهم مشاركين بأكتر من 5 أعمال في السنة
أحمد رفعت: بقالي 3 سنين مش بشتغل وفي فنانين بلاقيهم مشاركين بأكتر من 5 أعمال في السنة
 "القصص" يفوز بجائزة التانيت الذهبي أفضل فيلم طويل من أيام قرطاج السينمائية
"القصص" يفوز بجائزة التانيت الذهبي أفضل فيلم طويل من أيام قرطاج السينمائية
 احتفال صناع الفيلم القصير"32B: مشاكل داخلية" بجائزة التانيت الذهبي في مهرجان أيام قرطاج السينمائية ... صور
احتفال صناع الفيلم القصير"32B: مشاكل داخلية" بجائزة التانيت الذهبي في مهرجان أيام قرطاج السينمائية ... صور
 فيديو - عصام عمر ملاكم تلجأ له جيهان الشماشرجي في برومو "بطل العالم"
فيديو - عصام عمر ملاكم تلجأ له جيهان الشماشرجي في برومو "بطل العالم"
 رمضان 2026 - أيتن عامر تعتذر عن عدم استكمال مسلسل ظروف خاصة "حق ضايع"
رمضان 2026 - أيتن عامر تعتذر عن عدم استكمال مسلسل ظروف خاصة "حق ضايع"
 فيديو - أحمد الفيشاوي يقبل رأس شقيقه عمر في عزاء والدته سمية الألفي
فيديو - أحمد الفيشاوي يقبل رأس شقيقه عمر في عزاء والدته سمية الألفي
 صناع فيلم "هجرة": جوائز ليالي قرطاج إنجاز جديد للسينما السعودية
صناع فيلم "هجرة": جوائز ليالي قرطاج إنجاز جديد للسينما السعودية
 رمضان 2026- غادة عبد الرازق تستأنف مسلسل "عاليا"
رمضان 2026- غادة عبد الرازق تستأنف مسلسل "عاليا"
 عبد الرحيم كمال وإسعاد يونس نائبا لرئيس غرفة صناعة السينما هشام عبد الخالق
عبد الرحيم كمال وإسعاد يونس نائبا لرئيس غرفة صناعة السينما هشام عبد الخالق
 سيمفونية بصرية وصدمة سينمائية ... قراءة نقدية لفيلم "الست"
سيمفونية بصرية وصدمة سينمائية ... قراءة نقدية لفيلم "الست"
 إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" عبر القناة الأولى المصرية
إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" عبر القناة الأولى المصرية
 النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو بطل Breaking Bad: السينما المصرية مُلهمة .. وهذا سر ارتباطي بقصصها الإنسانية
النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو بطل Breaking Bad: السينما المصرية مُلهمة .. وهذا سر ارتباطي بقصصها الإنسانية
 حسن الرداد: فيلم "طه الغريب" سيكون عمل العمر .. فيديو
حسن الرداد: فيلم "طه الغريب" سيكون عمل العمر .. فيديو
 أحمد العوضي: مش محتاج أطلع إشاعات للدعاية لأعمالي وأنا فعلا الأعلى أجرا بالأرقام
أحمد العوضي: مش محتاج أطلع إشاعات للدعاية لأعمالي وأنا فعلا الأعلى أجرا بالأرقام
 أفلام من الذاكرة.. ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير
أفلام من الذاكرة.. ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير
 فيديو - ياسر جلال داخل المدبح من كواليس "كلهم بيحبوا مودي"
فيديو - ياسر جلال داخل المدبح من كواليس "كلهم بيحبوا مودي"
 فيديو - هشام ماجد يحير جمهوره بمفاجأة "اللعبة 5" شبيه مصطفى غريب
فيديو - هشام ماجد يحير جمهوره بمفاجأة "اللعبة 5" شبيه مصطفى غريب
 البجعة التي ابتلعت صاحبتها: رحلة الانهيار في Black Swan
البجعة التي ابتلعت صاحبتها: رحلة الانهيار في Black Swan
 "أشغال شقة جدا" يتصدر المشاهدة في "شاهد" عام 2025 وينافس على ثلاثة جوائز في Joy Awards
"أشغال شقة جدا" يتصدر المشاهدة في "شاهد" عام 2025 وينافس على ثلاثة جوائز في Joy Awards
أهم الأخبار
 جولة بالمنطاد ومركب في النيل وزيارة المعابد الفرعونية … رحلة بسمة بوسيل في الأقصر وأسوان
جولة بالمنطاد ومركب في النيل وزيارة المعابد الفرعونية … رحلة بسمة بوسيل في الأقصر وأسوان
 أحمد رفعت: بقالي 3 سنين مش بشتغل وفي فنانين بلاقيهم مشاركين بأكتر من 5 أعمال في السنة
أحمد رفعت: بقالي 3 سنين مش بشتغل وفي فنانين بلاقيهم مشاركين بأكتر من 5 أعمال في السنة
 #شرطة_الموضة: ريهام عبد الغفور بفستان قصير من Elisabetta Franchi في عرض "خريطة رأس السنة" … سعره 33 ألف جنيه
#شرطة_الموضة: ريهام عبد الغفور بفستان قصير من Elisabetta Franchi في عرض "خريطة رأس السنة" … سعره 33 ألف جنيه
 أيمن بهجت قمر: "طلقني" بيمثل تجربتي الشخصية
أيمن بهجت قمر: "طلقني" بيمثل تجربتي الشخصية








.jpg)