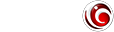قبل نحو ست سنوات دخلت بيتها في حي المنيل، منزل يمكن أن تقول عليه يحمل جمالا رغم جور الزمان، في الحقيقة لم يكن يهمني فقط أنها نجاة الصغيرة، ولكنها أخت محبوبتي- على طريقة عاطف السكري- سعاد حسني!
أثناء الحوار الصحفي أشارت لي نجاة الصغيرة على سرير بمحل إقامتها قائلة "هنا كانت سعاد بتحب ترتاح لما بتيجي عندي"!
هو سرير قديم، أو قل عليه بالأحرى "عتيق"، تفوح منه رائحة زمن كان يحمل- في الحقيقة- صورة ملونة بينما نحن- مع الأسف- نعيش في عصر الفن الأبيض والأسود!
نامت على هذا السرير سيدة استمرت أغلب عمرها بنضوج سيدة وجسد شابة مكتملة الأنوثة ومرح وانطلاق طفلة في العاشرة.
أخبرتني نجاة أن رغم سفر سعاد وهجرها لبلدها، إلا أنها لم تحمل نية لتغيير السرير أو فرش الغرفة الذي لم يأت عليه الزمن كأنه غرفة محصنة داخل هرم فرعوني.
سرحت وقتها في سعاد حسني، التي بدأت تعارفي معها عندما كانت تغني من كلمات صلاح جاهين "صباح الخير يا مولاتي"، في رائعة "هي وهي"، كان المسلسل يأتي معادا وقتها في فترة الظهيرة، تذهب والدتي إلى عملها بينما أتبقى أنا- في عمر السبع السنوات- منفردا مع السندريلا، وحدي في المنزل.
كانت السندريلا دائما ملازمة لنا كجيل، فرغم أنني من جيل الثمانينات الذي لم يعايشها، إلا أننا لم نكن بعيدين عنها.
كان ميعاد بدء الإجازة الصيفية مرتبطا باستعراض "خدنا أجازة"، فما أن تشدو السندريلا بها حتى يقف جميع أطفال الشارع ممسكين بكتبهم القديمة، ليرموها في الشارع معلنين أخذ ثأرهم من 9 شهور حرمان من الاستمتاع.
بينما عند بدء فترة المراهقة كانت صورة السندريلا تغيرت في أذهاننا، فأي شاب مصري يحلم بفتاة مثلها قائلا "عايز من دة"، وخد عندك من أفلام كانت تظل فيها كأنها "فينوس" تضيء قلوب عشاقها: البنات والصيف، وإشاعة حب، والسبع بنات، وعائلة زيزي، وشقاوة بنات، والعزاب الثلاثة وغيرهم.
ولكن السندريلا كانت "جرس الفسحة ضرب ضرب" هي النداء العالمي لجميع مدارس مصر للاستمتاع بـ20 دقيقة دون- ما اعتبرناه وقتها- عكننة "مستر عاطف" أو "مس عطيات"!
وعند فترة الشباب واهتمامنا بالشأن العام كان لا خلاف على رائعتي القاهرة 30 والكرنك.
رغم رحيل سعاد حسني فهي دوما ستزال كل مناسباتنا مرتبطة بها، حتى لو لم نعش في زمانها... روحها مع كل الأجيال!













.jpg)